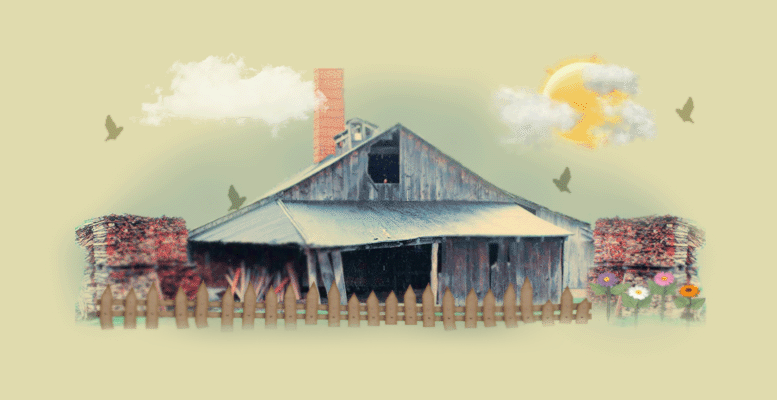أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف
أشاع رجال الدين في أوربا، في حملتهم الظالمة على الإسلام، ومعهم البابا بنديكت السادس عشر: أن الإسلام لم ينتشر في العالم إلا بحد السيف، وإخضاع الناس لعقيدته بالقوة العسكرية، ولولا هذا ما انفتحت له القلوب، ولا اقتنعت به العقول، ولكنها أكرهت عليه إكراها تحت بريق السيوف، فخيَّرهم بين الإسلام والقتل، فإما أن يسلم وإما أن يطير عنقه!
وقد قال الإمبراطور البيزنطي لمحاوره المسلم الفارسي فيما نقله عنه البابا: أرني ما الجديد الذي جاء به محمد، غير الأشياء الشرِّيرة وغير الإنسانية، مثل أمره بنشر دينه بحدِّ السيف؟! نقلها البابا نقل المسلِّم لها، المقرِّ بها.
وهذه فِرية تكذبها تعاليم الإسلام القطعية، وتكذبها وقائعه التاريخيه، ويكذبها المنصفون من المؤرخين المستشرقين أنفسهم.
فأما تعاليم الإسلام فهي تنفي الإكراه في الدين نفيا مطلقا عاما، بقوله تعالى في القرآن المدني: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ [البقرة:256].
وهو يؤكد ما جاء في القرآن المكي من قوله تعالى بصيغة الاستفهام الإنكاري: أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ [يونس:99]، وقوله تعالى على لسان نوح: أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ [هود:28].
وأما دعوى تخيير الناس بين الإسلام والسيف، فهي كذبة أخرى: فالثابت بالنصوص الشرعية، والوقائع التاريخية: أن المسلمين كانوا يخيرون مَن يقاتلونهم - إذا كتب عليهم القتال - بين أمور ثلاثة: الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. والجزية مبلغ زهيد يطلب من الرجال القادرين على القتال، ولا يؤخذ من امرأة، ولا صبي، ولا زَمِن، ولا أعمى، ولا فقير، ولا راهب في صومعته، وتتفاوت بتفاوت قدرات الناس، فكل على قدر طاقته، وطلب مثل هذا المبلغ - في مقابلة حمايته وكفالته والدفاع عنه - ليس شيئا باهظا يكره صاحبه على ترك دينه والدخول في الإسلام.
كما تقول وقائع التاريخ أيضا: إن المسلمين حينما فتحوا البلاد، لم يتدخلوا قط في شؤون دينها، ولم يُرغموا أحدا قط على تغيير عقيدته، ولم يثبت التاريخ واقعة واحدة أكره فيها فرد غير مسلم، أو أسرة غير مسلمة، أو بلدة غير مسلمة، أو شعب غير مسلم، على الدخول في الإسلام.
كما أثبت التاريخ أن كثيرا من البلاد الإسلامية التي نعرفها اليوم: لم يدخلها جيش مسلم، ولكنها دخلت في الإسلام بتأثير التجار وغيرهم من الناس الذين لم يكونوا علماء ولا دعاة محترفين، وإنما أحبهم الناس لما رأوا فيهم من صدق الإيمان، وحسن الخلق، وحب الخير للناس، فكانوا أسوة حسنة، فأحب الناس دينهم بحبهم، ودخلوا فيه أفرادا وجماعات. هكذا دخل الإسلام في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وغيرها: بوساطة تجار حضرموت وأمثالهم ممَّن جاءوا من جنوب اليمن، ضاربين في الأرض، مبتغين من فضل الله.
وهناك بلاد كثيرة في إفريقيا انتشر فيها الإسلام عن طريق الطرق الصوفية، وعن طريق الاحتكاك بالمسلمين، والتأثر بسلوكياتهم وآدابهم وأفكارهم.
وحتى البلاد التي دخلتها الجيوش: كان وجودها محصورا في العواصم والثغور، لا في كل المدن والقرى.
لم تدخل الجيوش الإسلامية التي فتحت الهند الكبرى، إلا في دائرة محدودة، ولكن انتشار الإسلام في القارة الهندية، كان أبعد وأوسع بكثير مما دخلته الجيوش، وامتدت دعوته شمالا وجنوبا، وشرقا وغربا، حتى كان من تأثيرها: وجود دولتين إسلاميتين كبيرتين هما: باكستان وبنجلاديش، ووجود أكبر تجمع إسلامي للمسلمين في الهند بعد إندونيسيا، برغم شكوى كثير من العلماء والناقدين من تقصير المسلمين خلال حكمهم الطويل للهند، من توصيل الدعوة للهندوس، ولا سيما دعوة طائفة (المنبوذين) للإسلام دين الأخوة والعدالة والمساواة.
السيف لا يفتح قلبا
ولقد اتخذ المبشرون والمستشرقون من الفتوح الإسلامية: دليلا على أن الإسلام إنما انتشر بهذه القوة والسرعة، نتيجة لأنه قهر الناس بالسيف، فدخل الناس تحت بريقه مذعنين طائعين.
ونقول لأصحاب دعوى انتشار الإسلام بالسيف: إن السيف يمكنه أن يفتح أرضا، ويحتل بلدا، ولكن لا يمكنه أن يفتح قلبا. ففتح القلوب وإزالة أقفالها: تحتاج إلى عمل آخر، من إقناع العقل، واستمالة العواطف، والتأثير النفسي في الإنسان.
بل أستطيع أن أقول: إن السيف المسلط على رقبة الإنسان، كثيرا ما يكون عقبة تحول بينه وبين قبول دعوة صاحب السيف. فالإنسان مجبول على النفور ممَّن يقهره ويُذلُّه.
ومَن ينظر بعمق في تاريخ الإسلام ودعوته وانتشاره: يجد أن البلاد التي فتحها المسلمون، لم ينتشر فيها الإسلام إلا بعد مدة من الزمن، حين زالت الحواجز بين الناس والدعوة، واستمعوا إلى المسلمين في جو هادئ مسالم، بعيدا عن صليل السيوف، وقعقعة الرماح، ورأوا من أخلاق المسلمين في تعاملهم مع ربهم، وتعاملهم مع أنفسهم، وتعاملهم مع غيرهم: ما يحببهم إلى الناس، ويقربهم من دينهم، الذي رباهم على هذه المكارم والفضائل.
وانظر إلى بلد كمصر، وقد فُتحت في عهد أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب، ولكن ظلَّ الناس على دينهم النصراني عشرات السنين، لا يدخل فيه إلا الواحد بعد الواحد. حتى إن الرجل القبطي الذي أنصفه عمر، واقتص لابنه من ابن والي مصر: عمرو بن العاص، لم يدخل في الإسلام، رغم أنه شاهد من عدالته ما يَبهر الأبصار.
وقد فنَّد الكاتب الكبير الأستاذ عباس العقاد هذه التهمة الباطلة في أكثر من كتاب له، ومما قاله:
(شاع عن الإسلام أنه دين السيف، وهو قول يصح في هذا الدين إذا أراد قائله: أنه دين يفرض الجهاد ومنه الجهاد بالسلاح، ولكنه غلط بيِّن إذا أريد به أن الإسلام قد انتشر بحد السيف، أو أنه يضع القتال في موضع الإقناع.
وقد فطِن لسخف هذا الادعاء كاتب غربي كبير، هو (توماس كارْلَيل) صاحب كتاب (الأبطال وعبادة البطولة) فإنه اتخد محمدا صلى الله عليه وسلم مثلا لبطولة النبوة، وقال ما معناه:
(إن اتهامه بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم. إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس، أو يستجيبوا لدعوته! فإذا آمن به مَن يقدرون على حرب خصومه، فقد آمنوا به طائعين مصدِّقين، وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها).
قال العقاد:
(والواقع الثابت في أخبار الدعوة الإسلامية: أن المسلمين كانوا هم ضحايا القسر والتعذيب، قبل أن يقدروا على دفع الأذى من مشركي قريش في مكة المكرمة، فهجروا ديارهم، وتغربوا مع أهليهم، حتى بلغوا إلى الحبشة في هجرتهم، فهل يأمنون على أنفسهم في مدينة عربية قبل التجائهم إلى (يثرب) وإقامتهم في جوار أخوال النبي عليه السلام، مع ما بين المدينتين (يعني: مكة ويثرب) من التنافس الذي فتح للمسلمين بينهما ثغرة للأمان؟ ولم يكن أهل يثرب ليرحبوا بمقدمهم لولا ما بين القبيلتين الكبيرتين فيها (قبيلتي الأوس والخزرج) من نزاع على الإمارة فتح بينهما كذلك ثغرة أخرى يأوي إليها المسلمون بعد أن ضاق بهم جوار الكعبة، وهو الجوار الذي لم يضق من قبل بكل لائذيه في عهد الجاهلية.
ولم يعمد المسلمون قط إلى القوة إلا لمحاربة القوة التي تصدُّهم عن الاقتناع، فإذا رصدت لهم الدولة القوية جنودها حاربوها؛ لأن القوة لا تحارب بالحجة والبينة، وإذا كفوا عنهم لم يتعرضوا لها بسوء.
وقد بيَّن الأستاذ العقاد أن المسلمين سالموا الحبشة ولم يحاربوها، وإنما حاربوا الفرس، وحاربوا الروم؛ لأنهم هم الذين بدأوا بالعدوان على المسلمين.
قال: ولم يفاتح النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالعداء في بلاد الدولتين. وإنما كتب إلى الملوك والأمراء يبلغهم دعوته بالحسنى، ولم تقع الحرب بعد هذا البلاغ بين المسلمين وجنود الفرس والروم، إلا بعد تحريضهم القبائل العربية في العراق والشام على غزو الحجاز، وإعدادهم العدة لقتال المسلمين. وقد علم المسلمون بإصرارهم على اغتنام الفرصة العاجلة لمباغتتهم بالحرب من أطراف الجزيرة، ولولا اشتغال كسرى وهرقل بالفتن الداخلية في بلادهما لبوغت المسلمون بتلك الحرب قبل أن يتأهبوا لمدافعتها والتحصن دونها)[1] اهـ.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه صـ219، 220.
قدرة الإسلام على الانتشار السلمي
لقد ذكرت في كتابي (تاريخنا المفترى عليه) وأعني بالطبع: تاريخنا الإسلامي: أن من مآثر هذا التاريخ: أنه سجَّل لديننا قدرته على الانتشار السريع، ودخول الأمم فيه أفواجا، بأدنى دعوة إليه، وإن لم يَقُم بهذه الدعوة أناس محترفون متخصصون في التبشير به، متفرغون له.
وسر ذلك: أن هذا الدين - بعقائده وعباداته وأخلاقياته وتشريعاته - تتوافر فيه: موافقة الفطرة، وملاءمة العقل، وتزكية النفس، وسمو الروح، وصحة الجسم، وتماسك الأسرة، وترابط المجتمع، وتحقيق العدل، وجلب المصالح، ودرء المفاسد، وإشاعة الخيرات، ومكافحة الشرور بقدر الإمكان.
وأبرز ما في هذا الدين سهولة عقائده التي ليس فيها غموض ولا التواء ولا تناقض، تقبلها الفطرة السليمة، ويسلم لها العقل المستقيم.
فلا غرو أن انتشر دين الإسلام انتشار أضواء الصباح، فملأ الآفاق، ومحا الظلام، واستنارت به الأبصار والبصائر، ورحب الناس به في عامة الأقطار.
الحق أن سهولة تعاليم الإسلام، وسمو أخلاق المسلمين: هما اللذان مهدا السبيل لدخول الأمم في الإسلام، وليس السيف، كما تقوَّل المتقولون.
انتشار الإسلام بفضائله وقوته الذاتية:
ولقد ألَّف المؤرخ المعروف الدكتور حسين مؤنس كتابا أسماه (الإسلام الفاتح)، وقال عنه: أنه دراسة في تاريخ البلاد التي فتحها الإسلام بفضائله وقوته الذاتية، دون أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب . وقد تتبَّع انتشار الإسلام في هذه البلاد، وبيَّن كيف دخل الإسلام إليه، بما يقطع كل شك، ويردُّ على كل تخرُّص بأن المسلمين استخدموا القوة في نشر دينهم . يقول د. مؤنس رحمه الله:
(لم يسبق فيما مضى أن كانت للمسلمين سياسة موضوعة لنشر الإسلام، يقوم عليها رجال متخصصون يجرون في أعمالهم على مناهج مقررة، كما هي الحال في النصرانية مثلا، حيث نجد البابوية الكاثوليكية، وما تبعها من منظمات كهنوتية كالفرنشسكية والدومينيكية والجزويت، وكذلك يما تنظمه الهيئات البروتستانتية من حملات تبشير، تعد رجالها في معاهد متخصصة، وتنفق عليها المال الوفير، ثم ترسلهم إلى البلاد البعيدة لدعوة الناس إلى أديانها بأساليب علمية مدروسة، لإقناع من يصادفونه من الناس بصدق ما يدعون إليه، وإدخالهم في العقيدة، ويبلغ الأمر أن يطلّق أولئك الدعاة الدنيا، ليخلصوا للدعوة خلوصا تاما، كما نعرفه في جماعات الرهبان المسيحية والبوذية أحيانا.
في الإسلام لا نجد شيئا من هذا إلا في عصرنا اليوم، عندما تزايدت تيارات التبشير غير الإسلامية، ولم يعد هناك مناص من أن يُعنَى المسلمون بالدعوة وتنظيمها، وإعداد الرجال القادرين عليها، فيما عدا ذلك كان الإسلام هو الذي نشر نفسه بنفسه: هو الذي دعا لنفسه واجتذب قلوب الناس؛ فأسلموا حبا في الإسلام وإعجابا به والتماسا لرحمة الله وهداه.
وإنه لمما يستوقف النظر أن قوة الإسلام الذاتية قد غلبت تنظيمات الدعاة، وأثبتت أنها أفعل وأبعد أثرا من المال الذي أنفقه الآخرون على دعاواهم، فانتشر واتسع مداه، ودخلت فيه الأمم بعد الأمم، من تلقاء نفسها بمجرد وصول الدعوة إليها. ولقد كان العرب يفتحون البلد من البلاد، ويعرضون الإسلام على أهله، ثم يدعونهم وشأنهم؛ حتى يقتنعوا بفضائله الإنسانية في تمهل، حتى لقد ذهب بعض الشانئين للعرب إلى أنهم لم يكونوا يهتمون بنشر دينهم، وأن الجزية كانت أحب إليهم من الإسلام، وما إلى ذلك مما نجده مسطورا في كتب أعداء الملة.
وما كان ذلك عن عدم حرص من العرب على نشر الإسلام، وإنما كان سيرا على أسلوب الدعوة في عهدها الأول: أسلوب عرض الدين على الناس، وتركهم بعد ذلك أحرارا إلى أن يهدي الله منهم من يشاء.
ومن غريب ما حدث في بلاد مصر والأندلس: أن كان مسلك العرب هذا أدعى إلى دخول الناس في الإسلام، لأنهم تعودوا ممن يتغلب على بلادهم: أن يكون شديد الحرص على إدخالهم في دينه، فما بال أولئك العرب لا يلحون على الناس في الدخول في الإسلام، ولا يستخدمون القوة في ذلك، كما كان رجال دولتي الرومان والروم يفعلون؟
قال يولوج الراهب القرطبي المبغض للإسلام: (فكان من مكر العرب أن تظاهروا بأنهم لا يهتمون بدخول الناس في الإسلام، فتطلعت نفوس الناس إلى ذلك الإسلام يتعرفون عليه، لعلهم يعرفون السبب في اختصاص العرب أنفسهم به، وضنهم به على غيرهم، فما زالوا يفعلون ذلك، ويسألون عن الإسلام ويستفسرون، حتى وجدوا أنفسهم مسلمين دون أن يدروا).
ولقد قال الراهب القبطي يوحنا النقبوس شيئا من ذلك، وكان متأسفا: لأن العرب لم يلجئوا إلى القوة في فرض الإسلام، إذ لو أنهم فعلوا ذلك لزاد تمسك الأقباط بعقيدتهم على مذهب العناد وإباء كل ما يفرض بالقوة، ولما وجد الإسلام هذا الطريق السهل الميسر إلى القلوب في مصر والأندلس.
وإنك لتحاول أن تدرس كيف أسلم أقباط مصر، وكانوا من أشد الناس استمساكا بعقيدتهم، حتى لقد استشهدت في سبيلها منهم جماعات بعد جماعات، على أيدي عتاة الرومان من أمثال دقلديانوس، وطغاة الروم من أمثال قيرس، فلا تجد لتساؤلك جوابا؛ لأن التحول إلى الإسلام في هذين البلدين - مصر والأندلس - تم في هدوء وسكون: انسابت العقيدة في قلوب الناس، كما ينساب الماء في أرض الزرع، فتخضر وتزهر وتثمر بإذن ربها.
وفي بلاد المغرب أسلمت قبائل البربر مبهورة بما رأت من روعة إيمان عقبة بن نافع وأصحابه، فهذا الرجل الفريد في بابه، الذي وهب نفسه للإسلام، كان يلقى رئيس القبيلة، ويحدثه، ثم يدعوه إلى الإسلام؛ فيسارع إلى الإيمان ليكون من قوم عقبة، ثم يتبعه بعد ذلك قومه.
إن مداخل الإسلام إلى القلوب، هي سماحته وبساطته وإنسانيته. إنه يقدم للمؤمن به الاطمئنان وهدوء البال، ويفتح له إلى الله سبحانه بابا واسعا للمغفرة والأمل وثواب الآخرة، وكل ذلك دون مقابل. في أديان أخرى تفرض عليه أموال وهدايا وقرابين، ويلزم بطاعة رهبان وقساوسة، ويراقب ويعاقب ويحرم من نعمة الله بقرار.. لا شيء من هذا في الإسلام، من هنا كان مدخله إلى النفوس سهلا ذلولا.
أما مسالك الإسلام، فهي ضروب الأرض جميعا: لقد انتشر الإسلام بالبر والبحر، بالحرب والسلم، لقد اخترق الجبال والشعاب، وأوجد لنفسه طرقا ومسالك لا تخطر على بال أحد. لقد اشترك في نقل الإسلام حتى الكفار، ومن بين المستشرقين رجل - سنتحدث عنه - نصح حكومته بترك الإسلام ينتشر، حتى يشتغل به الناس، ويتركوا التجارة والأموال للهولنديين، وأخذت الدولة بكلامه.
وانساح الإسلام في إندونيسيا حتى عمها كلها. وحدث أن دخلت الإسلام قبيلة من قبائل الونقارة في غرب أفريقية على سبيل العناد مع جارتها، فلما دخلت فيه سعدت وارتقت وسادت وتبعتها خصمتها الأولى… بفضل هذه العداوة - التي أصبحت صداقة - اخترق الإسلام مائتي كيلومتر من الغابات الاستوائية التي لا يخترقها أحد إلا بمشقة، وهذه القبيلة - وتسمى الونقارا آيا - تعتبر في مقدمة قبائل داهومي، منها اليوم أطباء ومهندسون ومدرسون وقضاة. لقد دخلت الإسلام دون أن تدري أي حظ كتبه الله لها عن طريق هذا الدين.
الإسلام دين طيار
والخلاصة أن داعية الإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه، فقد تضمنت عقيدته وشريعته من الفضائل ما يجعل الناس يحرصون أشد الحرص على أن يدخلوا فيها، ثم إن الإسلام يعطي الداخل فيه كل شيء ولا ينتقصه شيئا، فإن الإنسان يكسب الصلة المباشرة بالله سبحانه وتعالى، ويجد الطريق إليه فيقف بين يديه خمس مرات في اليوم، ويدعوه دون حجاب، ويكسب الأمل في حياة أسعد وأرغد في هذه الحياة الدنيا، ثم حياة الخلود في دار البقاء، ولا يكلفه ذلك إلا النطق بالشهادتين، واتباع شريعة الإسلام، وكلها خير ومساواة وعدل، في حين يتقاضاه رجال الدين في الأديان الأخرى- كما قلنا - الإتاوات في كل مناسبة، فهو يؤدي مالا إذا تزوج، ويؤدي مالا كلما أنجب ولدا، ويؤدي مالا ليعمِّد الطفل الوليد، ثم مالا آخر ليثبته في الجماعة المسيحية إذا ضرب في مداخل الشباب، بل يؤدي مالا إذا مات له ميت لكي تصلى عليه صلاة الجنازة، وبالإضافة إلى ذلك يظل عمره كله تابعا لرجل الدين في كل ما يتصل بالله سبحانه، فإذا أراد الصلاة صلى عنه القس، ووقف هو يسمع ولا يملك إلا أن يقول: آمين، ولكن المسلمين وحدهم من دون أهل الأديان هم الذين يقوم كل واحد منهم بصلاته بنفسه، حتى لو كانت صلاة الجماعة، وفي غير الإسلام يصلي القس مع مساعديه نيابة عن الناس.
والحق أن أصدق وصف يطلق على الإسلام في هذا المقام، أنه (دين طيار) ينتقل من إنسان إلى إنسان ومن أمة لأمة في سهولة ويسر، كأن له أجنحة قدسية تحمله وتجري به مجرى الريح! وإنك لتنظر إلى خريطة الأرض، وتتأمل مدى انتشار الإسلام، فتتعجب من سعته، ويزداد عجبك عندما تتبين أن ثلث هذه المساحة فحسب هي المساحة التي فتحتها الدول وأدخلت الجيوش فيها الإسلام. أما الباقية فقد دخلها الإسلام، وملأ قلوب أهلها دون جيش منظم، أو سياسة مرسومة لذلك!! إنما هو الإسلام نفسه، جعله الله خفيفا على القلوب، قريبا إلى النفوس، ما تكاد كلمة الحق تصافح أذن الرجل حتى يصل الإيمان إلى قلبه، فإذا استقر في قلبه لم يكن هناك قط سبيل إلى إخراجه منه، فهو الريء الذي تظمأ إليه النفوس وتستقي منه، وهو الأمل الذي يخفف على الإنسان وطأة المسير في هذه الدنيا، ويهون عليه الموت، فالموت ليس آخر رحلة الإنسان مع الحياة بل هو المدخل إلى الحياة فحسب، وبعد هذه الحياة حياة هي أسعد وأبقى لمن صدق إيمانه واتقى.
ولعل أكبر أسباب خفة الإسلام على القلوب هو: وضوحه وصدقه، فإنك إذ تؤمن بالإسلام لا تؤمن بأسرار أو أمور لا يقبلها عقلك، كما ترى في الأديان الأخرى، حتى الغيب الذي تؤمن به في الإسلام حقيقة، فإن الإنسان لا يرى الله بالعين المبصرة، وإنما يحس به في نفسه، وفي كل ما حوله بالبصيرة المنيرة، والحقيقة الكبرى في هذا الكون هي خالقه، فهو الحق ولا حق غيره، وأنت لا تؤمن بالله؛ لأن داعيك إليه يأتي بمعجزات أو خوارق، وإنما هو يلفت نظرك إلى عجائب الخلق، وكلُّ ما فيه معجز وخارق، وأنت تراه رأي العين في شخصك الذي يعيش ويتحرك ويفهم، لا تدري كيف، فإذا لم تؤمن بالله فكيف فكيف تعلل حياتك، وحركة حسدك، ونبض قلبك ؟ فإذا آمنت بالله لم يكن لك مفر من أن تؤمن بنبيه الذي حمل إليك رسالته، فالله سبحانه حق، ونبيه صدق، وكل ما يعدك به القرآن حق وصدق، ولست تحتاج إلى من يشرح لك حقيقة الإسلام حتى في نفسك، وغاية ما تحتاج إليه من يذكرك بها، وهذا معنى من معاني تسمية الله سبحانه للقرآن بالذكر والذكر الحكيم[1] اهـ .
شهادة غوستان لوبون
وهذه شهادة مؤرخ كبير مثل الدكتور حسين مؤنس، ولكن قد يقال: إنها شهادة مسلم لدينه. فهذه شهادة من مؤرخ غير مسلم، وهو المؤرخ الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي الشهير (غوستان لوبون) في كتابه (حضارة العرب) الذي نقله إلى العربية الأستاذ عادل زعيتر.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الإسلام الفاتح لحسين مؤنس صـ20 – 24، نشر الزهراء للإعلام العربي.
فلسفة القرآن وانتشاره في العالم
يقول لوبون تحت عنوان (فلسفة القرآن وانتشاره في العالم):
إذا أرجعنا القرآن إلى عقائده الرئيسة: أمكننا عدُّ الإسلام صورة مبسطة عن النصرانية، ومع ذلك فإن الإسلام يختلف عن النصرانية في كثير من الأصول، ولا سيما في التوحيد المطلق الذي هو أصل أساسي، وذلك أن الإله الواحد، الذي دعا إليه الإسلام، مهيمن على كل شيء، ولا تحفّ به الملائكة والقديسون وغيرهم ممن يفرض تقديسهم . (أي كما في النصرانية) وللإسلام وحده أن يباهي بأنه أول دين أدخل التوحيد إلى العالم.
ويشير لوبون إلى يسر الإسلام، وسهولته البالغة والتي تتمثل في عقيدة التوحيد الخالص، وفي هذه السهولة سر قوة الإسلام، وهي التي تجعل إدراك الإسلام سهلا على كل إنسان، فليس في الإسلام غموض ولا تعقيد، مما نراه في الأديان الأخرى وتأباه الفطرة السليمة، من المتناقضات والغوامض.
قال: ولا شيء أكثر وضوحا، وأقل غموضا، من أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحد، وبمساواة جميع الناس أمام الله. وببضعة فروض يدخل الجنة من يقوم بها، ويدخل النار من يعرض عنها. وإنك، إذا ما اجتمعت بأي مسلم من أية طبقة، رأيته يعرف ما يجب عليه أن يعتقده، ويسرد لك أصول الإسلام في بضع كلمات بسهولة. وهو بذلك على عكس النصراني الذي لا يستطيع حديثا عن التثليث، والاستحالة، وما ماثلهما من الغوامض، من غير أن يكون من علماء اللاهوت الواقفين على دقائق الجدل!
وساعد وضوح الإسلام البالغ: ما أمر به من العدل والإحسان كل المساعدة، على انتشاره في العالم، ونفسر بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام، كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية، فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام، كما نفسر السبب في عدم تنصر أية أمة، بعد أن رضيت بالإسلام دينا، سواء أكانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة.
ويجب على من يرغب في الحكم بفائدة كتاب ديني: ألا ينظر إلى قواعده الفلسفية الضعيفة على العموم، بل إلى مدى تأثير عقائده . والإسلام إذا ما نظر إليه من هذه الناحية: وجد أنه من أشد الأديان تأثيرا في الناس، وهو - مع مماثلته لأكثر الأديان في الأمر بالعدل والإحسان والصلاة، إلخ - يعلِّم هذه الأمور بسهولة يستمرئها الجميع، وهو يعرف، فضلا عن ذلك، أن يصبّ في النفوس إيمانا ثابتا لا تزعزعه الشبهات.
ولا ريب في أن نفوذ الإسلام السياسي والمدني كان عظيما إلى الغاية، فقد كانت بلاد العرب قبل محمد مؤلفة من إمارات مستقلة وقبائل متقاتلة دائما، فلما ظهر محمد، ومضى على ظهوره قرن واحد، كانت دولة العرب ممتدة من الهند إلى إسبانية، وكانت الحضارة تسطع بنورها الوهاج في جميع المدن التي خفقت راية النبي فوقها.
والإسلام من أكثر الديانات ملائمة لاكتشافات العلم، ومن أعظمها تهذيبا للنفوس، وحملا على العدل والإحسان والتسامح، والبُدّهِيةُ، وإن فاقت جميع الأديان السامية فلسفة، تراها مضطرة أن تتحول تحولا تاما لتستمرئها الجموع، وهي، لا شك، دون الإسلام في شكلها المعدّل هذا.
وجرت حضارة العرب، التي أوجدها أتباع محمد، على سنة جميع الحضارات التي ظهرت في الدنيا: نشوء فاعتلاء فهبوط فموت، ومع ما أصاب حضارة العرب من الدُّثور، كالحضارات التي ظهرت قبلها، لم يمس الزمن دين النبي الذي له من النفوذ ماله في الماضي، والذي لا يزال ذا سلطان كبير على النفوس، مع أن الأديان الأخرى التي هي أقدم منه تخسر كل يوم شيئا من قوتها.
ويدين بالإسلام في الوقت الحاضر أكثر من مائة مليون شخص[1]، واعتنقته جزيرة العرب ومصر وسورية وفلسطين وآسية الصغرى وجزء كبير من الهند وروسية والصين، ثم جميع إفريقية إلى ما تحت خط الاستواء تقريبا.
وتجمع بين مختلف الشعوب التي اتخذت القرآن دستورا لها وحدة اللغة والصلات التي يسر عنها مجيء الحجيج إلى مكة من جميع بلاد العالم الإسلامي.
وتجب على جميع أتباع محمد تلاوة القرآن باللغة العربية بقدر الإمكان، واللغة العربية هي لذلك أكثر لغات العالم انتشارا على ما يحتمل، وعلى ما بين الشعوب الإسلامية من الفروق العنصرية ترى بينها من التضامن الكبير ما يُمكِن جمعها به تحت علم واحد في أحد الأيام.
وقضى أعداء الإسلام من المؤرخين العجب من سرعة انتشار القرآن العظيمة، فعزوها إلى ما زعموه من تحلل محمد وبطشه، ويسهل علينا أن نُثبت أن هذه المزاعم لا تقوم على أساس، فنقول: إن من يقرأ القرآن يجد فيه ما في الأديان الأخرى من الصرامة، وإن ما أباحه القرآن من تعدد الزوجات لم يكن غريبا على الشعوب المسلمة التي عرفته قبل ظهور محمد، وإن هذه الشعوب لم تجد نفعا جديدا في القرآن لهذا السبب.
وما قيل من دليل حول تحلل محمد نقضه العلامة الفيلسوف (بيل) منذ زمن طويل. وقال بيل، بعد أن أثبت أن ما أمر النبي بالتزامه من قيود الصيام وتحريم الخمر ومبادئ الأخلاق هو أشد مما أمر به النصارى:
(إن من الضلال، إذن، أن يُعزى انتشار الإسلام السريع في أنحاء الدنيا إلى أنه يلقي عن كاهل الإنسان ما شق من التكاليف والأعمال الصالحة، وأنه يبيح له البقاء على سيئ الأخلاق، وقد دوَّن (هوتنجر) قائمة طويلة بالأخلاق الكريمة والآداب الحميدة عند المسلمين، فأرى - مع القصد في مدح الإسلام - أن هذه القائمة تحتوي أقصى ما يمكن أن يؤمر به إنسان من التحلي بمكارم الأخلاق، والابتعاد عن العيوب والآثام)[2].
ومما نبه إليه العلامة (بيل): أن ملاذ الجنة التي وعد بها المسلمون لا تزيد على ما وعد به النصارى في الإنجيل . جاء في الإنجيل: (لم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب إنسان: ما أعده الله للذين يحبونه).
وسيرى القارئ، حين نبحث في فتح العرب وأسباب انتصاراتهم: أن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم، فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام، واتخذوا العربية لغة لهم، فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل.
وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة، فلما قهر النصارى عرب الأندلس فضل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم على ترك الإسلام.
ولم ينتشر القرآن بالسيف إذن، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول، وبلغ القرآن من الانتشار في الهند، التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل ما زاد معه عدد المسلمين على خمسين مليون نفس فيها[3]، ويزيد عدد مسلمي الهند اليوم يوما فيوما، مع أن الإنجليز، الذين هم سادة الهند في الوقت الحاضر، يجهِّزون البعثات التبشيرية ويرسلونها تباعا إلى الهند لتنصير مسلميها على غير جدوى.
ولم يكن القرآن أقل انتشارا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قط، وسترى في فصل آخر سرعة الدعوة الإسلامية فيها، ويزيد عدد مسلميها على عشرين مليونا[4] في الوقت الحاضر.
وليس فيما يوصم به الإسلام من الجَبْرية ما يزيد خطرا على ما رددنا عليه، وليس في آي القرآن التي ذكرناها آنفا من الجَبْرية ما ليس في كتب الأديان الأخرى كالتوراة مثلا[5]. وهناك فلاسفة وعلماء لاهوت يعترفون بأن مجرى الحوادث تابع لسنة لا تتبدل، قال المصلح الديني القدير لوثر: "يحتج على اختيار الإنسان وإرادته بنصوص الكتاب المقدس التي لا تحصى، وإن شئت فقل بكل ما ورد في الكتاب المقدس".
وكتب جميع الأمم الدينية مُفَعَّمَة بالجَبْرية التي يسميها القدماء بالقدر، ووضع القدماء القدر، الذي لا راد لحكمه، على رأس كل أمر، عادِّين إياه سلطة مطلقة لا مناص للناس والآلهة من إطاعتها، وحاول (إديب) على غير جدوى، أن يضرع إلى هاتف الغيب الذي أخبره بأنه سيقتل أباه ويتزوج أمه، فلم يستطع ردا لحكم القدر الجبار.
ولم يكن محمد، إذن جَبْريا أكثر من مؤسسي الأديان الذين ظهروا قبله، ولم يسبق محمد في جبريته علماء الوقت الحاضر الذين أيدوا مع العلامة لابلاس رأي الفيلسوف ليبنتز في القول: (إنه إذا وجد ذكاء يعرف، لوقت، جميع قوى العالم، ومواضع ما فيه من الموجودات، ويستطيع أن يحللها، ويحيط بمحركات أعظم أجرام العالم وأصغر ذراته، فإنه لا يبقى عنده شيء غير معين، ويصبح الماضي والمستقبل حالا في نظره).
والجَبْرية الشرقية التي قامت عليها فلسفة العرب، ويستند إليها كثير من مفكري العصر الحاضر هي نوع من التسليم الهادئ الذي يعلم به الإنسان كيف يخضع لحكم القدر من غير تبرٌّم وملاومة، وتسليم مثل هذا هو وليد مزاج أكثر من أن يكون وليد عقيدة، وقد كان العرب جبريين في مزاجهم قبل ظهور محمد، فلم يكن لجربيتهم تأثير في ارتقائهم، كما أنها لم تؤد إلى انحطاطهم[6] اهـ.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- قيل هذا في القرن التاسع عشر، ومع هذا كان المسلمون أكثر من ذلك بكثير، وسيأتي من كلام (لوبون) نفسه ما يدل على أن المسلمين أكثر من ذلك.
[2]- وقال الفيلسوف الشهير (كارلايل) في كتابه الأبطال، في فصله الذي كتبه عن البطل في صورة نبي، واتخذ النبي محمدا نموذجا ممثلا للبطولة: (إن دينه ليس بالدين السهل، فإنه – بما فيه من صوم قاس، وطهارة، وصيغ معقدة صارمة، وصلوات خمس كل يوم، وإمساك عن شرب الخمر - لم يفلح في أن يكون دينا سهلا) انظر: الدعوة إلى الإسلام صـ460 لتوماس أرنولد.
[3]- هذه إحصائيات قديمة من القرن التاسع عشر، ومع هذا ليست دقيقة.
[4]- إذا كان المسلمون في الهند يزيدون على 50 مليونا، وفي الصين على 20 مليونا، فكيف يكون عدد جميع المسلمين مائة مليون، كما قال الباحث من قبل؟!!
[5]- بل هناك مئات الآيات من القرآن في سوره المكية والمدنية تثبت بكل وضوح: أن الإنسان مكلف مختار، وأنه هو الذي يقرر مصير نفسه، وإن الله تعالى منحه من القوى والمواهب والملكات: ما يمكنه من صنع مصيره بيده، كما قال تعالى: {مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} [الاسراء:15]، {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر:38]، {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة:286]، {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5] … إلى آخره.
[6]- انظر: حضارة العرب.
توماس أرنولد ينصف الإسلام
وإذا كان غوستاف لوبون الفرنسي قد أنصف الإسلام وتاريخ المسلمين في كتابه، فقد جاء بعده المستشرق البريطاني البحاثة الشهير (توماس أرنولد) الذي كان يعرف العربية والفارسية وعددا من اللغات الأوربية، والذي أصدر كتابه القيم (الدعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية) وكان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، (1896م).
وقد طبع الكتاب بالإنجليزية عدة طبعات، ونقله إلى العربية د. حسن إبراهيم حسن وزميلاه، ونشر عدة مرات ابتداء من سنة 1947م .
والكتاب جدير بأن يقرأ، لما فيه من وقائع وأحداث مأخوذة من مصادر عدة وموثقة، ومكتوبة بلغات شتى، عكف الرجل عليها، حتى استخرجها من مظانها وحشدها في كتابه العلمي الموثق.[1]
وكلها تؤكد هذه الحقيقة التي وضحت وضوح الشمس في ضحى النهار: أن الإسلام لم ينتشر قط بالسيف في أي البلدان، ولا في أي عصر من الأعصار؛ بل انتشر بالسلم، وبالدعوة الهادفة، وبأخلاق المسلمين، وبسهولة فهم عقائد الإسلام وتعاليمه، ونحو ذلك من عوامل التأثير السلمي، الذي لا يشوبه أي لون من ألوان القوة المادية.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- انظر: كتابنا (تاريخنا المفترى عليه) صـ197 – 209.